1. ما المجرى الروحي؟ ولماذا نعني بالمجرى الروحي ذلك
النور الذي يغمر قلب الكائن فينجذب إلى المطلق بنفس
مطمئنة، توّاقة إلى ابتكار ما يبهج ويسعد ويؤنس الموجودات
في الكون، مرضاة لذلك النور، واستئناساً به، واستلذاذاً
لتجلياته، وابتهاجاً بأسراره ولطائفه، ونشداناً لحبه في
أزليته... لحب كائناته التي تسبِّح لجلاله من حيث هي دارية
أو غير دارية.
فهذا النور؛ وبهذا
المعنى؛ هو الذي نحتاج إليه، لأنه الوحيد الذي باستطاعته
رفع الشقاء الأنطلوجي عن الإنسان المعاصر، ودفعه إلى
اعتناق الكون ومفرداته بحميمية غير مشوبة بكراهية ولا
ضغينة، ولا أنانية ولاجبروت، ولا نفعية فاجرة.. وذلك لأنها
حميمية ألفة وتآلف، وسكن وسكينة، وغبطة وطمأنينة. تجسِّر
ضفتَي الوجود بالعمل الأحبّ والممتع، وتحسِّس الإنسان بأنه
في أبدية مطلقة، لا تغيب عنه شمس الوجود.
وبهذا يدرك أنه آيل للخلود، وإن كان لمحة في عين الزمن
الطويل، ومجرد مخلوق عابر، وذرة من تراب الأرض، تقضم
الساعات جزءاً من ذاته كما يقضم البحر قسماً من الساحل،
وتبتلع اليابسة جزءاً من البحر، فتقرع أجراس الأسى وتنشر
رناتها الحزينة. وأن الحاضر هو الماضي المغلق يتفاعل
المبادرات، والماضي هو الحاضر المنفتح أمام العقل المتفهم
فلسفياً.. ومع ذلك فإنه يتيقن بأن ذلك نزوع إلى الكمال
الذي لا وجود له في دنيانا حيث الرؤية الشاملة ما هي إلا
خدعة نظر.
إن الإنسان مخلوق تاريخي محكوم بالجغرافيا، والجغرافيا هي
أم التاريخ ورحمه، وأم الإنسانية التي ربتها ونظمت حياة
بنيها. والزمن حركتها التي تفجر طاقاتها. وعندما يستعاض
كلياً عن طاقات البحر بطاقات الجو في مجالات النقل والبحر
ستتغير الجغرافيا، وسيشهد الإنسان حتما انقلاباً في حياته
وسلوكه يضعف معه أثر العامل الجغرافي بسب نمو التقنية
الفاحش، وسيتضاعف المتسولون من الجنوب على أعتاب الشمال.
أليس محزناً إلى درجة الموت أن يكون الجنوب الذي ابتدع أهم
المدنيات وأعرقها متسولاً الشمال الذي أخذ تلك المدنيات
وسيطر عليها، ودكَّ أركانها؛ بعد أن استوحاها؛ ثم جاء الآن
ينشرها مجدداً؟!. لاشك أن الأحوال الجغرافية والاقتصادية
والسياسية تبتدع الثقافة، والثقافة تكون النموذج البشري،
ولاشك أيضا أنه لاشيء في التاريخ أكثر وضوحاً من وقوع
المنتصرين المهيمنين في الأخطاء عينها التي أدانوها لدى
المنهزمين الذين تغلبوا عليهم.
2. نفعية فاجرة
لقد ولدنا حقا؛ نحن البشر؛ غير
أحرار وغير متساوين، بل أسرى تراثنا البدني والنفسي
وعاداتنا وتقاليدنا ونظام بيئتنا، واختلاف بعضنا عن بعض
متجلٍّ في الصحة والقوة والمواهب والصفات والسجايا، وليس
هناك مطلقا اثنان يتشابهان تمام التشابه، وهذا برهان على
فرادة كينونة كل إنسان، وعلى أن استكناهها يقوم بإضاءة
القلب وجذبه إلى المجرى الروحي الذي لا تتكدَّر فيه النفس
بكوابيس الوجود.
وحين يتأتى هذا
لن ينظر الإنسان إلى نفسه على أنه ذلك الإله الأرضي؛ الذي
وصفه كارليل بكونه يكبر في غير زمانه ومكانه، ولا ذلك
السوبرمان القاهر لكل شيء، وإنما سيعتبر نفسه مطيّة
الأحداث ورمزها، وعميلها وصوتها المدوّي. يسبح في نهر
التقليد والتجديد تبعاً للَواعج أهوائه، ولَواعج الأهواء
أشبه بنهر من النار، لابدَّ من أن يغطيه رماد الحذر،
وتبرِّد لظاه مئاتُ التحفظات والامتناعات وإلا أصبحت
الإنسانية في فضاء سديمي تزأر فيه النفعية الماجنة، وتنطلق
فيه الرذائل جامحة مهدِّدة الإنسان والوجود، ومحجِّرة
نضارة الحياة وغضارتها. إن أخوف ما يخاف منه على الإنسان
هو أن يأتي يوم يدوس فيه الفضائل ويمجد الأهواء تحت ذرائع
التحرر والارتقاء، وابتداع تاريخ لم يبتدعه من سبقه، ولا
خطر بباله امتطاء رياحه.!
ويقيناً
أن المجرى الروحي هو الذي يهذِّب هذا النزوع، ويجعل المرء
لا يرى وجهة نظر فولتير (1964م- 1778م) في التاريخ حين
اعتبره في معظمه مجموعة جرائم، وضروب من الجنون وخيبات
الأمل، أصابت البشرية في الصميم، وأشعلت فيها ملذّات ساقطة
تأنف منها حتى البهائم. بل يعده عين الزمن التي يبصر بها
الحضارة الإنسانية في جنونها وعقلانيتها، في امتدادها
وانكماشها، في سفالتها وسموِّها، في شكِّها ويقينها، في
تفاعلها وأنانيتها، في وفاقها واصطدامها مع ذاتها انطلاقا
من بعد فلسفي. ولذلك فإنه لا وفاق ممكناً بين المجرى
الروحي والمجرى الفلسفي إلا من خلال إقرار الثاني بأنه لم
يجد بديلا عن الأفق الروحي، ومن خلال اعتراف الأول بأن
حرية الإنسان في إبداع ما يسعده على الأرض ويرفع عنه
الشقاء هي من جملة ثوابته (1).
3.
نزوع شره
وتحت هذا التصدع في الرؤية كانت
المفارقة، والمفارقة هي أن منجزات الإنسان الحضارية لم تكن
في عمقها مدينة للثورات بقدر ما هي مدينة للنزوع المادي
الشره والرغبة في الاستحواذ. فهذا النزوع هو الذي دفع
قديماً أجاممنون وأخيل وهكتور إلى السيطرة تجارياً على
مضيق الدردنيل، لا محيَّا هيلانة الأحلى من نسيم الصباح
والمشرق أكثر من ألف كوكب. وأموال اتحاد داليان هي التي
بنت صرح البرثينون، وثروة كليوباطرا Cléopâtre (69 ق.م- 30
ق.م) هي التي أنعشت بلاد الرومان المرهقة في عهد أغسطس
Auguste (63 ق.م- 14م)، ومنها منح فرجيل جعالة سنوية،
وهوراس Horace (65 ق.م-8 ق.م) مزرعة. واكتشاف أمريكا كان
ردّة فعل إزاء فشل الصليبية في السيطرة على طرق الشرق
التجارية. ومصارف مديسيس Médicis هي التي موَّلت النهضة
الفلورنسية.
لقد اندلعت الثورات فعلا، لكن محركها ليس هو الفكر المحض،
بل النزوع المادي. فالثورة الفرنسية 1789م –التي هي أشهر
الثورات- لم تقم بسبب ما كتبه فولتير من انتقاد لاذع، ولا
بتأثير روايات روسو العاطفية، وأفكار ديريدو. بل لأن
الطبقة المتوسطة توصّلت إلى التحكُّم في الاقتصاد، فاحتاجت
إلى الحرية القضائية لتنفيذ مشاريعها، وتحقيق الأرباح
التجارية والحصول على ما افتقرت إليه (2).
وإنه لمن المفرح أن يحب الإنسان الحرية ويتفانى في عشقها.
ولكن الحرية تتطلب شيئاً من آداب السلوك، وأول شروط الحرية
هو وضع حدود لها، لأنها عندما تكون مطلقة لا بد لها من أن
تجمح وتتردى في فوضى ليس لها قرار، وأن تكون غطاءً لما
يناقضها. ألم يعلن ديوكلسيانوس أن على الحرية الفردية أن
تحتمي في ظل الحرية الجماعية لتبرير حربه الاقتصادية؟ وقد
استند إلى حجّة أن الحرية لا بد لها من التضاؤل كلما ازداد
الخطر الخارجي.
وربما كان الخوف واحداً من أسباب
السلوك التي تنعش الحرية. فالخوف من الرأسمالية اضطر
الاشتراكية - قبل أن تتوفى- إلى توسيع مجال الحرية نسبياً،
والخوف من الاشتراكية دفع الرأسمالية - قبل أن تتعولم- إلى
مضاعفة المساواة.
ويبقى الأمل في
تخفيف الشقاء عن إنسان هذا العصر مرهوناً بالوجود
الديمقراطي. فالديموقراطية سلوك وتخليق للحياة العامة،
وقاطرة البناء الحضاري الأعلى، لا يهددها الاختلاف المشبع
بروحها، ولا انجراحات الواقع الذي تعمل فيه، وإنما الذي
يهددها حقاً هو ذلك المرض المسمى ب(ضغط المال)؛ الذي يريد
التغلغل في شرايينها/ وتحويلها لصالحه، وهو مرض قديم. ففي
جمهورية أفلاطون أدان سقراط (470 ق.م- 393 ق.م) أثينا التي
نبذ فيها الديموقراطيون كل اعتدال كأنه بادرة غير إنسانية،
وكل تعلق بالروح وبالقيم البناءة. ووصفها بأنها فوضى العنف
والإرهاب وانحلال الأخلاق وانحطاط الثقافة. وبعد موت
أفلاطون (428 ق.م –348 ق.م) استعادت أثينا ثراءها في
ميادين التجارة أكثر من استعادته في ميادين استثمار الأرض،
وصار الصناعيون والتجار والصيارفة في رأس ذوي النفوذ
والجاه، وانقسمت أثينا إلى مدينتين: الأولى جنة الأغنياء
المترفين، والثانية جحيم الفقراء المحرومين. وراحتا
تتحاربان بكل الوسائل. واشتط الأغنياء في تصرفاتهم، فراحوا
يفضلون رمي مقتنياتهم الفائضة إلى البحر على مدّ العون
للمحتاجين. وتسرّب الفساد إلى الديموقراطية، وانقلبت
موازين القوى، وظهر ضغط المال على التطور السياسي
والديموقراطي.
وكما حدث في أثينا
حدث في روما، فقد تضاعف أصحاب الملايين، وحلّت الأموال
النقدية محل الأملاك كقوة وكعدة في أيدي رجال السلطة
السياسية، وتزاحم المرشحون المتنافسون على كسب الأصوات في
الانتخابات حتى إن مجموعة من الناخبين في سنة 53 ق.م تلقت
عشرة ملايين سيستر (= وحدة العملة ) لمنح أصواتهم، وعندما
لم يف المال بشراء الضمائر وتحقيق المراد، لجأ المتنفذون
الماليون المصمِّمون على إفساد الديموقراطية إلى اغتيال
المرشحين، وإلى ضرب المواطنين الذين أساءوا اختيار الأشخاص
غير المرغوب فيهم، والتضييق عليهم في معاشهم وحياتهم (3).
هل معنى هذا أن الديمقراطية بعيدة المنال؟
كلا؛ وإنما هي من أصعب أشكال الحكم، لأنها تتطلب أرضا
روحية صلبة وقيماً عليا خلاّقة، كما تتطلب كذلك استخدام
أكبر قدر من البراعة والذكاء، وأكبر قدر من الوعي
بالجغرافيا والتاريخ والمحيط الكوني. ومهما يكن فإنها إن
أضرّت فضررها أقل قليلا من نفعها الكثير، فهي وحدها التي
باستطاعتها إعطاء الوجود الإنساني نكهة فاخرة، ونفحة
عاطرة، تعوض عن كل عيوب ونقائص أشكال الحكم الأخرى التي
عرفها الإنسان، وتمنح الفكر والعلم والفن حرية أساسية
لاغنى عنها للتحرك والنمو والازدهار، وتحطم حواجز
الامتيازات والطبقات، وتعلي شأن المهارات عبر مختلف
المراتب والمستويات، وتصمم على نشر الثقافة والمعرفة
والفن، وصيانة الصحة العامة التي هي أساس كل عمران. فالناس
– وإن لم يكونوا متساوين في الواقع – يجعلهم حصولهم على
الثقافة والعلم، وإمكانية النجاح، وفرص التسابق، أقرب
للتساوي، وهذا كله بفضل الديمقراطية.
غير أنه لا ينبغي أن يحجب عن البال تلك الحالة التي قد
تنفلت فيها بعض الحكومات الديموقراطية، فتتحول إلى حكومة
حرب مسيطرة تحت ذرائع برّاقة ومخادعة. إذ مهما بدت هذه
الحكومة بليغة الكلام، ساحرة البيان، موفورة العدّة، فإنها
ستكون لا محالة عبئا ثقيلا على كاهل دول العالم أجمع.
فالديموقراطية إبداع وازدهار، وأفق رخاء وتعايش مفتوح على
الكون، وليست حروبا لتكريس الأنانية.
وليتذكر إنسان اليوم تلك الخمسة والعشرين مليوناً من البشر
الذين قتلتهم في الحرب العالمية الأولى رصاصة واحدة انطلقت
ذات يوم أرعن في سراييفو، وليتذكر ضعف ذلك في الحرب
الكونية الثانية (4). فنحن لا نريد للألفية الثالثة أن
تنجرف مع مقولة " الحروب من ثوابت التاريخ"، حقاً إن
الحروب لم تخف وطأتها بسبب تحجر روح الإنسان وموت القيم
النبيلة فيه، إذ من بين 4321 عاماً التي اشتملت عليها
صفحات التاريخ لم تكن حصة السلام فيها تتجاوز 268 فقط.
أليس هذا محزنا ومخيفا ودالاًّ على شراسة البشرية وشغفها
بالدمار؟! إنه لشقي الإنسان وكنود رغم مباهج تقنياته ما
دام لم يستطع بذكائه ومؤهلاته أن يكتب صفحات في التاريخ لا
تعرف الدم. لقد غدا بوسع حرب واحدة أن تدمر ما اقتضى بذل
جهود جبارة متواصلة خلال قرون لتشييد المدن وابتكار الفنون
وتنمية مقومات الحضارة إذا لم تلجمها قوة روحية ومثل سامية
(5).
4. سجين ملكوت الآلة
فبعد أن كان الإنسان في القرن الماضي سجيناً بئيساً في
ملكوت الآلة، يجر جراحاته النفسية الطاوية لإشباع شره
الصناعة أصبح الآن عبداً ذليلاً في يد التقنيات العالية؛
التي مكنت البعض من القدرة الكلية على التهديم والإبادة
القصوى متحدياً بذلك كل الشرائع المقدسة سماوية كانت أو
غير سماوية، وصاغت البعض الآخر من داخله الفكري والنفسي
حسب ما تريد، لا حسب ما يريد هو، يتلفَّت حوله فيجد أنه
يعيش وهماً قاتلاً وكابوساً مرعباً في عالم من الكذب
المنظم والأضاليل المقنعة..عالم كل ما فيه يصنع صنعاً،
تقنيته الفائقة هي التلاعب بالعقول، واستخدام العلم
والأساطير لخلق القضايا الكبرى وقتلها، وشلّ حركة الروح،
والعبث بالحالات البشرية الفكرية والوجدانية وتقليبها وفقا
لما يشاء أولئك الأشباح المهيمنون الذين يتفرجون من خلف
الستار ويضحكون بلذة الشيطان (6) أبتر وجدان الإنسان
المعاصر ومسخت روحه إلى حد استلذاذه بالشر، وازدهائه
بالقدرة على المحق؟!.
إنه إذا تسنّى لحرب كونية ثالثة –وذلك ما تخافه الإنسانية
المعافاة وجدانياً وفكرياً ولا تريده– أن تكتسح المدنية
الحالية فإن ما سينجم عنها من دمار شامل وتمزيق وفقر، ومن
تدهور علمي وثقافي وسياسي واجتماعي وإنساني سيجعل من كوكب
الأرض جحيماً أفظع بكثير مما هو عليه الآن بالنسبة للبعض.
فهل المجرى الروحي كفيل بمنع وقوع مثل هذا الرعب في
الأرض؟
إن المجرى الروحي سيبقى
دائماً الأمل الوحيد والمرشد الأمين، وزورق النجاة في نظر
الذين تأملوا عبر التاريخ، أو الذين بقوا أحياء بعد كوارث
رهيبة وشاملة. وذلك لأن له أكثر من حياة، فهو على الدوام
ينهض من بين الأنقاض ليعزّز الأخلاق، ويلجم الانحراف،
ويرصّ النفوس والعقول لتلافي الكوارث، ويفتح أبواباً جميلة
للحياة لم ترها قط النزعة القائمة على تقديس العقل كإله،
وما دام في الدنيا فقر وشقاء، وتكالب على السلطة والثراء،
فإن الحاجة إلى هذا المجرى ستزداد، سواء لدى المعدمين أو
لدى المنعمين، فهؤلاء لم تسعد نفوسهم بما ملكوا، وأولئك
أشقى نفوسهم الحرمان. فالشقاء النفسي قاسم مشترك بينهما،
يصبّحهما ويمسّيهما، ولن يرفعه عنهما إلا المجرى الروحي
إذا استبقا إليه (7).
وإذا اضمحلت الأمم ؟!
سيبقى الإنسان المندمج في المجرى الروحي، لكونه ذلك الفطن
الذي يحمل عدته الروحية والثقافية والعلمية والفنية ويرحل
مصطحباً ذكرياته. فإذا تأصَّلت في أعماقه جذور تلك العدة،
وتوسَّعت آفاق مداركه، هاجرت الحضارة معه، واتخذت لها
موطنا في مكان آخر حل فيه. وفي ملاذه الجديد لن يحتاج هذا
الإنسان إلى الانطلاق من البداية على كل الأصعدة، ولا إلى
أن يشق طريقه بمعونة أي صديق، فالمواصلات تشده إلى مقره
المختار كأنه في أرض آبائه وأجداده. وكما أن الحياة تخطَّت
الموت بالتناسل، فكذلك الحضارة، فهي تتخطّى الموت والجمود
حينما تنتقل ثمارها الطيبة إلى أولاد الإيمان وأحفاده (8).
5. فشل المعرفة وضبط الأهواء
المعرفة قوة، هكذا
هتف فرانسيس بيكون، وهكذا نهتف معه الآن... ولكن ألا نشعر
في بعض الأحيان بأن العصور الوسطى وعصر النهضة التي حطَّت
من قيمة الميثولوجيا، وروَّجت الفنون، هي أقل حكمة من
سواها لأنها وسّعت معارفنا دون أن تحسّن نوايانا وتطمْئِن
وجداناتنا؟!. لقد مزج التقدم في العلوم والتقنيات بعض
ألوان الشر بالخير، وربما سبّب الرفاه والراحة إضعاف
النشاطات البدنية ومناعة الأدبيات والأخلاقيات، فوسائل
التنقلات والحروب نمت بشكل هائل ومذعر، مما سهل ارتكاب
الجرائم وقتل البشرية ببرودة أو حتى قتل النفس أحيانا،
فعادت التصرفات والعادات اليوم أفظع مما كانت عليه بالأمس.
والعادات –كما قال الذين أتعبوا الخرائط بالسفر– تميل إلى
الأسوأ كلما ابتعدت عن الشرق باتجاه الغرب. فهي مبتذلة في
آسيا، وبذيئة في أوروبا، لكنها قبيحة ومنحطة في الولايات
المتحدة الأمريكية.
أو ليس جميع ما أحرزته
الفلسفة من تقدم؛ منذ ديكارت (1596م –1650م)؛ بمختلف
مذاهبها وتياراتها ليس سوى وهم وضلال بسب فشلها في
الاعتراف بدور الميثولوجيا في تعزية الإنسان، ودور المجرى
الروحي في تهذيب سلوكه، وتحسين عاداته، وضبط أهوائه،
وإسعاد وجوده وحياته؟! (9). وقد قيل إن من زادت معلوماته
-هذا قرن المعلوميات بامتياز- طغت عليه أحزانه. فهل في فيض
الحكمة! الروحية ما يغسل الأسى العصري، ويكون سلواناً
للإنسان عن توالي الخيبات والخسرانات، ويقيه من منطق
الصراعات الذي ما ينفك التبشير به يتعالى؟.
فالأمر ليس أمر صراع الحضارات ونهاية التاريخ كما يروّج
هنتينجتون وفوكوياما في أطروحتيهما، بل الأمر أمر نفوس
منخوبة، ووجدانات فصمت علاقتها بالمطلق، فتهيأ لها أنها
قادرة على التأله في الأرض، وتفعل في الطبيعة ما تشاء،
وتستحوذ على مقدرات الشعوب والأمم، وخيرات الأرض بدعوى
مصالحها الاستراتيجية. وما المصالح الاستراتيجية إلا قناع
للشره المادي والنزوع الاستكباري. وإلا فإن الحضارة الحق
هي التي تفجر سؤال الإبداع والاختلاف، بوصفها نظاماً
اجتماعياً ينمِّي الثقافة الخلاقة، ونظاماً ديموقراطياً
تؤمنه شهامة التقاليد وعدالة القوانين، تماماً كما يؤمّن
النظام الاقتصادي تواصل الإنتاج الجيد، وتكافؤ المصالح
المتبادلة. لا تزدهر إلا إذا غذّتها الحرية الحق، وشجعتها
الابتكارات، وصراحة التعبير، وخبرة التجربة. ودعمها تفتح
الأذهان والأفكار، وتألّق الآداب والفنون، وائتلاف العادات
الرصينة.
وهذه كلها علاقات دقيقة
بين البشر، أَوْهَى من خيوط العنكبوت، تنشأ بالجهد الجهيد،
وتزول بمنتهى السهولة. ففي بلاد الإغريق حطم الفلاسفة
قديماً إيمان الطبقة المتعلمة للسيطرة عليها (أو ليست
المعرفة قوة كما عبر بيكون ؟!)، واليوم في كثير من الشعوب
الغربية توصل الفلاسفة إلى نتيجة مماثلة، ففولتير تقمّص
شخصية بروتاغوراس، و روسو (1712م –1778م) شخصية ديوجينوس،
و هوبس (1588م-1679م) شخصية ديموقريطس، و كانت Kant (1724م
– 1804م) شخصية أفلاطون، و نتشه Nietzsche (1844م – 1900م)
شخصية ثراسيماخوس، و سبنسر Spencer (1820م – 1903م) شخصية
أريسطوطاليس، و ديدرو Diderot (1713م – 1784م) شخصية
إبيقوروس، قديماً وحديثاً على حد سواء قامت الأفكار عبر
تحليلاتها المتطرفة بهدم ركائز الدين الذي يصون كالسياج
النفوس من الضياع والبحران (10). فنبع زمن مثقل بالشك
والحذر والاستسلام إلى الملذات، وغدا الكائن البشري عدو
ذاته، وعدو بني جنسه وغير بني جنسه من الكائنات، يغتصب
الطبيعة بلذة مازوكية.
6. ثورة
لتحقيق الوجود
وسيبقى الكائن الإنساني على هذه
الحالة الشاذة، إلى أن يصفِّي زمنه من أوحال الشك الأعمى،
وأوهام العقل الزاعم أنه ناهض وحده، من طنين الثورات
الدموية التي تعصف بالوجود، وتبدد الثروات في أغلب الأحيان
سدى، ولا تعدل توزيعها. فالزمن هو وعاء العمل الحضاري،
وتلغيمه تلغيم للحضارة، وضياعه ضياع للوجود الإنساني، وقد
نبّه إلى هذا المفكر مالك بن نبي، حين حلل شروط النهضة
الحضارية، فأشار إلى أن مشكلة الحضارة تنحل إلى ثلاث
مشكلات أولية؛ هي: مشكلة الإنسان، ومشكلة الأرض ومشكلة
الزمن.
أما الثورة؛ بما هي إنقاذ
للإنسان واكتشاف لقواه الخيرة، وإلجام لنوازغه ونوازعه
الماكرة السوداء؛ فهي التي يقوم بها المجرى الروحي حين
ينور الأذهان، ويقوم الأخلاق. أي يحرر الإنسان من نواقصه
بصورة فعلية، ويفتح أمامه سبل الكمالات للتنافس فيها،
وبذلك يحقق له وجوداً حياً. وليس من ثوار حقيقيين في هذا
المجرى غير الأنبياء والمصلحين والمفكرين والمبدعين
ومعانقي المطلق، فهم وحدهم الرافضون للتراخي الذي لا يولد
إلا حرية الفوضى، وضياع القيم، وفجور الوقاحة، وبؤس
الإنسان.
7. المجرى الروحي رؤية
خاصة للعالم
فالمجرى الروحي من هذه الوجهة يعطي
الإنسان رؤية خاصة للعالم، تلهم وجدانه وفكره ضمن الفئة
الاجتماعية التي ينتمي إليها، وتبين له نمط التعامل وأسلوب
العيش، وبهذا يتكون لديه مصدر أساسي للثقافة التي هي عملية
انبنائية Structuration ومحصلة المعلومات المختلفة
الملتقطة من العلاقات المتعددة.
وكلما ترقرق المجرى الروحي في النفوس نهضت شجرة الحضارة
شامخة وارفة، لأنها ترتوي أساساً من نبع الإيمان بالله،
وبالغيب والوحي الإلهي، وتخاف الانحراف عن مسؤوليتها في
إسعاد البشر على الأرض، وليس في ذلك ما يخرجها عن
العقلانية، لأن العقل لا ينهض وحده، ولا يستطيع تفسير
الوجود، ولا توحيد المجتمعات. ولعل أعسر ما يتحدّى العقل
والعلوم الأرضية الآن -وفي كل زمان- هو معرفة "عالم
الغيب"، والغيب يعني ما وراء الحسّ، لأن الحسَّ يحُول بين
الإنسان وعالم الغيب. فهل يمكن إزالة الستار كما يقول
الصوفية؟ إن الستار ليس شيئاً مادياً، وإنما هو الإطار
الذي تتحدد به الحواس في إدراكها للموجودات التي يمكن أن
يتحدد وجودها في الزمان أو المكان، أو لا يتحدد ذلك الوجود
في أي منهما بأي شكل، وعند ذلك تستحيل رؤيتها، ومثل ذلك
الصوت المستمر في الكون؛ والذي نسمعه باستمرار؛ أصبح من
المستحيل معرفته والشعور به. وكذلك النور الذي يغشى البصر
دون انقطاع يستحيل إدراك معناه. أليس بضدها تتبين
الأشياء؟. ولهذا قال الصوفية إن الله نور اختفى بشدة
إشراقه، فهو نور لا يدرك لفرط ظهوره، وهو الله لا يغيب ولا
يخلو منه الزمان والمكان، لأنه (نور السموات والأرض)...
وعليه فإن السبب في خفاء الغيب يرتبط بعدم قدرة حواس
الإنسان على الإدراك، وكما لا يدرك اللمس المبصرات، و لا
يدرك البصر المسموعات، فكذلك لا يدرك عقل الإنسان -وهو
الآلة- عالم الغيب الخفي. وقد صدق سقراط حينما قال: إن
القول فيما لا يحاط به جهل، ورفضه هو جهل الجهل (11).
وعلى ضوء هذه الرؤية تتأسس الحضارة كبنية
فوقية تصاحب الوجود الاجتماعي للإنسان، وترتبط بتطوره
الفكري في مقابل الثقافة التي هي مزيج من التعليم والحضارة
والعقيدة والتراث. فقد يكون الإنسان متعلماً حاذقاً، ولكنه
مع ذلك لا يكون مثقفاً، وقد يكون مثقفاً وليس له قدر كاف
مما تتناوله التربية الأساسية. وقد تكون الأمة ذات حضارة
عريقة ولكن ليست لها الثقافة التي تؤهِّلها. فالحضارة إذن
هي بنية فوقية أو واجهة أمامية، والثقافة هي بنيتها
العميقةInfrastructure المحاورة باستمرار للفكر والاقتصاد
والفن والأدب والسلوك، مما ينتج عنه التوازن بين التطور
المادي والتطور الروحي.
وبهذا تكون الثقافة فكراً مترجماً إلى عمل، والعمل حركة
دينامية تبرز الفكر، إذ لا ثقافة مع غياب العمل، ولا عمل
وبناءً حضارياً مع غياب الثقافة. وكما أن هناك ثقافة فردية
تربي الملكة والذوق والنفس والجسم، فكذلك هناك ثقافة
اجتماعية تقر النظام والعدل والأمن، وتتجه إلى الطبيعة
والآلة والفلاحة والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن
لتطويرها بالبحث والتصنيع، وبهذا تتشخص حياة المجتمع،
ويتجلى ما نطلق عليه اسم "الحضارة" (12) وهي مختلفة
باختلاف البيئات على مر التاريخ، وباختلاف معطيات تلك
البيئات التي لها انعكاس على طبيعة الثقافات. فالبيئة
الجغرافية – والجغرافيا هي رحم التاريخ وأمه الحاضنة –
الإغريقية ذات الجبال العالية والرياح العاصفة أوحت
بالميثولوجيا للإغريق، بينما توحي الصحراء بالهواجس
الداخلية والحدوس التي تنمِّي الإحساس الباطني، كما أن
ظلال الأشجار الباسقة في الأدغال الموحشة مما يطبع حضارة
الغاب بالحذر والوحشة، والبيئة الساحلية المعتمدة على
البحار حفّزت على المغامرة واقتحام عالم المجهول.
وهدف الحضارات على اختلاف بيئاتها هو تحقيق
حركة التاريخ لتطور الإنسان وتقدمه متكاملاً في دائرة
الاقتصاد والفكر والوجدان والعلم والتقنية. فبالتعرف على
حضارة مجتمع من المجتمعات البشرية يتم التعرف على أنواع
النشاطات الفكرية والوجدانية والإبداعية والتقنية، وعلى ما
يتوقعه أفراد ذلك المجتمع من بعضهم ومن غيرهم. وذلك لأن
الحضارة من حيث طبيعتها ووظائفها ذات وحدة في المجتمعات
كلها، والخلاف بينها في نوعيتها فقط (13). لكن بعض الآراء
تكشف -من حيث توهجها- عن اختلاف غاية الحضارة، فالذين
عندهم مجرى روحي وقيمي يرون أن الحضارة لها بداية، ولها
نهاية، ونهايتها يوم قيامتها. فعندما تنتهي أعمال
الإنسانية على الأرض سيسأل الإنسان عما فعل في حياته،
وحضارة كهاته تكون دائماً حضارة واعية ومرتبطة بالمستقبل
الأخروي. بينما يرى هيجل (1770م–1831م) أن الحضارات تجارب
بشرية، وهي فلسفات متعددة، ولكل حضارة فلسفتها، وحضارة كل
أمة لها روح ولب Geis، وكيان خلقي وتنظيم اجتماعي، ومن
تفاعل هذين مع حركة الزمن تنشأ حركة التاريخ. أما شبنجلر
Spengler (1880م – 1936) فإنه يفسر قيام الحضارات وسقوطها
بناءً على تصور عضوي لبناء الجماعات، ويأتي بعده توينبي
Toynbee ليبين أن قيام الحضارات يخضع لنظرية التحدي
والاستجابةChallenge and respouse ؛ التي تنظر إلى التاريخ
كوحدات حضارية، لا كعصور ودول. فالحضارة في رأي توينبي لا
تفنى آثارها حتى بعد تحللها The disintegration لأنها تخلف
وراءها طابعاً حضارياً حياً فاعلاً يدخل في كيانه شعوباً
أخرى، وبهذا تلتقي بحضارة أخرى، فتتكون حضارة جديدة، كما
يلتقي الجدول بالجدول ليكون نهراً كبيراً، وفي هذا
الالتقاء لا يمكن أن يكون السبق هو الأساس الحضاري، لأن
فلسفة التركيب الحضاري لا تعني إفلاس الحضارات ونهايتها،
بقدر ما تعني تفاعلها واستمرارها.
والحضارة؛ بما هي كذلك؛ لها جانبان:
أ- جانب العلم والتكنولوجيا، وهو مشترك بين جميع أبناء
البشر في كل الأزمنة.
ب- جانب القيم، وهو
يختلف بين مجموعة بشرية وأخرى، لأنه متغير مع الزمن، وعاكس
للتنوع العصري في الإنسان.
فالجانب
الأول يمكن نقله من جهة إلى أخرى، أما الثاني فمستحيل
نقله؛ لأنه خصوصية ثقافية تتألف من أنماط صريحة وضمنية
للسلوك المكتسب، ومن أفكار وآراء موروثة، ولها مجالات
مترابطة تتجسد في: المجال العقدي، والمجال الاجتماعي،
والمجال الثقافي، وأي تغيير في إحدى هذه المجالات يحدث
تغييراً في الخصوصية، وهزة عنيفة في كينونة الإنسان وجسده
الوجودي. فالقيم ثقافة حركية دينامية، والحضارة ثمرتها.
وكل تغيير في الحركة أو اهتزاز فيها سيؤدي لا محالة إلى
إفساد الثمرة أو إسقاطها (14). ولذا ينبغي عند التنادي إلى
حوار بين حضارة الشرق وبين حضارة الغرب أن تستحضر جوانب
وغاية كل منهما، ليتأتى للحوار أن يكون فعالاً ومثمراً،
ومبنياً على حقائق وتصورات موضوعية، لا على خلفيات
إيديولوجية ومكبوتات تاريخية. فمثلا الحضارة الغربية
غايتها هو تجسيد المطلق، بينما الحضارة الشرقية غايتها هو
تنزيه المطلق. وبين الغايتين هوة لن يتسنى ردمها أبدا، فما
العمل؟ أيطوى الحوار؟ وتعلن الجفوة والقطيعة؟ أم يستمر
بعيداً عن هذا المنحى الذي لن يفيد الخوض فيه أحداً، لأن
المطلق هو المطلق، دائم كماله، ولا يتأثر بتصورات البشر
الفانين عنه؟!.
7-1 تجاوز اللغة
واستساغة الآخر
أمام موقف كهذا لا يبقى إلا الأخذ
بما جاء في "شروط النهضة" و "ميلاد مجتمع" لمالك بن نبي،
فهو يعتبر الثقافة جسراً للحضارة وتعلما لها، لأنها نسق من
التفكير والإنتاج والسلوك والمعاملة. أما الحوار فهو الأرض
الدائمة التي يتم فيها تلاقح الحضارات المختلفة، وكل حوار
لا تعززه ثقافة إنسانية صلبة ذات بعد سلمي لن يكون مآله
غير الفشل والخيبة للطرفين المتحاورين معاً، وغير إحباط
الإنسان التوَّاق إلى الاتصال.
إذ من خصائص الإنسان أنه حيوان رامز، يسعى دائماً إلى أن
يتصل بمجتمعه الأصغر الذي هو أمته، وبمجتمعه الأكبر الذي
هو الإنسانية جمعاء. وهذا التعاطف الاتصالي يسمو على
اللغة، لأنها وسيلة المجتمع القومي. ولذلك يلاحظ أن الصلة
الثقافية الحق هي التي تربط بين المفاهيم الإنسانية
متجاوزة بذلك اللغة التي هي وسيلة لخدمة الإنسان في مجتمع
ضيق نسبياً. ولهذا تجد في المجتمعات العربية والإسلامية
استساغة لآراء سقراط و أفلاطون و أريسطو وهيراقليطس وروسو
وفولتير ودي كارت وكانت وبنسر وكونت (1798م – 1857م) ونتشه
وغوته Goethe (1749م – 1832م) وهيجل وهيدجر (1889م –
1979م) وماركس (1818م – 1883م ) وفرود (1856م – 1939م)
وبرغسون (1859م – 1941م) وراسل (1872م – 1970م) وشوبنهاور
(1788م – 1860م) وسبينوزا (1632م – 1677م) وسارتر (1905م –
1980م) أكثر من الاستساغة لآراء الباباوات ورجال الكنيسة،
لتقارب الهدف الثقافي. وبالمقابل تجد صلة الغرب بابن رشد
وابن خلدون ومسكويه والفارابي وإخوان الصفاء وابن سينا
وابن باجة وابن طفيل وابن حزم والمعري والخيام والمتنبي
وابن عربي والحلاج والسهروردي والرازي وابن سبعين وابن
مسرة أكثر من صلته بأئمة المذاهب الفقهية وفقهائها. (15)
7-2 التطلع إلى غاية أبدية مطلقة للوجود
ومن هذا
التقارب في الهدف الثقافي ينبغي الانطلاق لتأسيس وجود
حقيقي على الأرض تتعايش فيه كل الأنماط الحضارية بغض النظر
عن ثوابتها ومرتكزاتها. فالغرب لا يكفر بالله، وإن كان قد
أسّس حضارته ومناهج حياته على أساس علماني منكر لليوم
الآخر عند الأغلبية، ولكن هذا لم يمنع بعضهم من أن يكون
مؤمناً بالله وباليوم الآخر. وكذلك الشرق مؤمن بالله
وباليوم الآخر، ولكن هل يقيم حضارته ومناهج حياته على أساس
هذا الإيمان؟ ألا يوجد فيه من لا يتعدى إيمانهم حدود
المعتقد النظري والمشاعر النفسية الفردية؟!
أكيد أن هدف إنسان الحضارة الغربية قاصر على الاستمتاع
بمتاع الدنيا إلى أبعد الحدود، ومثل هذا الهدف يحرم بلا
ريب الإنسان من التطلع إلى غاية أبدية مطلقة لوجوده، ويفصل
الدنيا عن الآخرة، وبذلك يهدم الحياة بالاستنزاف. بينما
الحضارة التي لا يفصل هدفها الدنيا عن الآخرة ترى أن
المادية والروحية لازمتان لسعادة الإنسان، وقيام الحياة
الصحيحة لا يتحقق إلا بخضوع المادية للروحية، وإلا قست
الحياة وفسدت. فالروحية إطار عام للحضارة، ومحرك أساسي
لابتكاراتها المادية المؤمثلة، وبخاصة إذا فهمت الروحية
بمفهومها الشامل لمختلف جوانب الحياة.
7-3 من أجل وجود سيال تكبر فيه الحرية
وبهذا
يتحقق التطور والصيرورة، ويتميز البعد الأنطولوجي للإنسان،
وتبرز إنسانيته كحقيقة متضمنة للتضاد، عكس ما كان قدماء
الفلاسفة يقولون به، فهم كانوا يرون أن الشيء الحقيقي هو
الذي لا يتحول ولا يتغير، فإذا تبدل فذلك دليل على عدم
وجوده، ووجود النقيض في كينونته معناه عدم ثباته، ولذلك لا
يعتبر حقيقة، ولا يكون معرفة، لأن الحقيقة والمعرفة تبنيان
على الثوابت. ولهذا كان أفلاطون يرى أن اجتماع الأضداد في
الأشياء مما ينزلها من سلم الموجودات، وسار أريسطو على خطا
أستاذه فأسس المنطق على الكينونة لا الصيرورة، وهذا منشأ
الخلل الذي قوضه بعد ذلك الغزالي وابن تيمية وابن حزم،
وديكارت وهيجل وراسل. فمنطق أريسطو ارتكز على ثلاثة مبادئ؛
هي: "العقلانية"، و "السببية"، و "الماهية". وقد رفض هيجل
هذه المبادئ، وقال إن المنطق عنده يقوم على التضاد، وعلى
استمرارية التنقل من الموضوع إلى اللاموضوع، ومن البسيط
إلى المركب، ومن الإيجاب إلى السلب.
ومن هنا جاءت فلسفة الوجود والعدم لتؤكد التطور والصيرورة،
إذ جميع القضايا وجميع الأفكار، وجميع النظريات والآراء،
فيها جوانب السلب والإيجاب، سواء في المفاهيم والمنظومات
الفكرية، أو في التعابير اللغوية، فجملة (ليس خالد واقفاً)
هي (خالد جالس). فالإيجاب والسلب موجودان حتى في التعبير
اللغوي، وإذن فالوجود والعدم بينهما ترابط وعلاقة، أي سلب
الربط وربط السلب، فمصداق السلب ومصداق الإيجاب واحد،
والمقابلة بينهما تولد الصيرورة أي التدرج والسيلان، أو ما
عبر عنه برغسون بالوجود السيال، وهو يعني بالوجود السيال
أن يكون وجوداً مستمراً.(16)
وبهذه الصيرورة، وفيها، نرى الإنسان في حياته يعمل وفق
قانون الطبيعة دون تدخل لإرادته، وأحياناً بتدخل هذه
الإرادة، فيكون مسيّراً إذا جهل قوانين الطبيعة، ومخيّراً
إذا عرفها. وكما قال الغزالي: "كلما كثرت معارف الإنسان
كبرت حريته".
الهوامش
1. ول وايل ديورانت: عبر التاريخ، تعريب:
أنطوان رزق الله مشاطي، ط1 ، دار العلم للملايين، بيروت،
يونيه 1993م، ص: 64.
2. المرجع السابق، ص: 75
3. نفسه، ص: 112
4. شاكر مصطفى: قضايا من
التاريخ، ط1، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق
1996م، ص: 70
5. عبر التاريخ، مرجع مذكور، ص:
119
6. قضايا من التاريخ، مرجع مشار إليه، ص:
134
7. عبر التاريخ، ص: 70
8.
المرجع السابق، ص: 140
9. نفسه، ص: 144
10. نفسه، ص: 139
11. قضايا من التاريخ، ص:
104
12. الحسن السائح: الحضارة المغربية
البداية والاستمرار، منشورات عكاظ، مارس 2000، 1/13
13. المرجع السابق، 1/14
14. نفسه، 1/31
15. نفسه، 1/27
16. نفسه،1/53
شاعر وباحث من المغرب
awabouarham@gmail.com
http://www.awabbelhaj.jeeran.com
ahmedbelhajayateouarham@maktoob.com
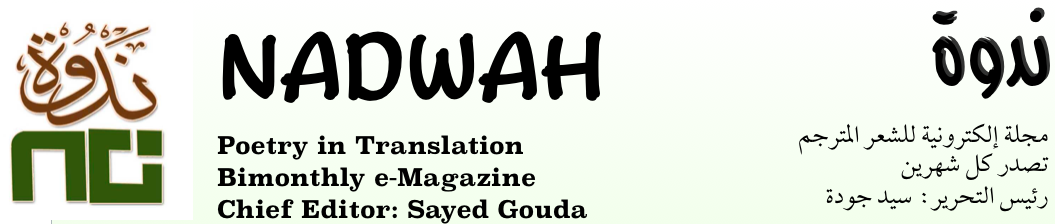 ف
ف
